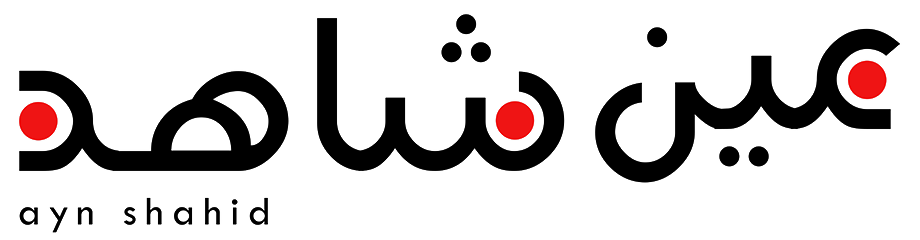همام طه
في المشهد السياسي والبيروقراطي العراقي، لا تزال “الزيارة التفقدية” التي يجريها المسؤولون للدوائر الحكومية والمناطق السكنية تحظى بهالة رمزية تُقدَّم بوصفها دليلاً على حرص المسؤول وتفانيه وقربه من الناس. لكن خلف هذا المشهد المتكرر، الممتد من سرديات “الخليفة العادل الزاهد” الذي يتجوّل ليلاً والناس نيام ليصغي إلى شكوى رعيّته، إلى صور “القائد الحريص الحنون” وهو يقتحم مطابخ البيوت ويفتح قدور الطعام ليطمئن على قوت شعبه، تختبئ بنية سلطوية تتغذى على منطق السلطان والرعايا، والأمير والرعيّة، لا على مبادئ الدولة الحديثة ومفاهيم المواطَنة.
فالزيارات الميدانية والجولات التفقدية، كما تُمارَس اليوم، ليست فعل رقابة مؤسساتي أو واجباً وظيفياً، بل هي نزوع استعراضي موروث من تاريخ مضى وروايات تراثية مثالية النزعة، وأيضاً من نظام استبدادي، أعاد تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع بوصفها علاقة فوقية تقوم على الوصاية والعطف، وكذلك على الخوف والانصياع والتصفيق.
وتُستمد فكرة “تفقّد السلطان للرعيّة” من صورة درامية حالِمة متجذرة في تراثنا الثقافي. فقد نشأنا على سردية “الحاكم العادل” الذي كان يجوب المدينة متخفياً تحت جُنح الظلام ليستكشف أحوال “رعيّته” المعيشية ويصغي إلى أوجاعهم ومعاناتهم من خلف الجدران والأبواب الموصدة، ليُصدر في الصباح قراراته التي يصحح بها الخطأ ويحقق العدل وينصف المظلوم ويقوّم الاعوجاج في سياسات الدولة. وقد طوّر هذه الصورة التراثية وكرّسها الرئيس الأسبق صدام حسين خلال فترة حكمه، ولكن بشكل معلن واحتفالي وجماهيري، من خلال زياراته المتلفزة لمنازل العراقيين في الريف والمدينة وفتحه الثلاجات وأواني الطعام على المواقد للتأكد من أن شعبه يأكل كما ينبغي وأن الدولة تشمل “الرعيّة” بعطفها وحنانها. لذلك تجد المسؤولين اليوم، بعد زوال نظام صدام، يسارعون إلى التقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل المقاطع الفيديوية أثناء ما يسمى “زيارات تفقدية” أو “جولات ميدانية” أو “متابعة سير العمل” أو “إشراف مباشر على تقديم الخدمات للمواطنين” في محاكاة دعائية لتراث استعراضي أرساه رأس النظام السابق. كما أن لكبار المسؤولين اليوم وحتى صغارهم مكاتب إعلامية متخصصة ومجهزة بالعدّة والعدد ومموّلة من المال العام لتوثيق أنشطتهم وتسويقها للإعلام بوصفها “إنجازات” للدائرة التي يرأسها المسؤول.
ومرة أخرى، تستبطن هذه الفكرة، “تفقّد المسؤول للمواطنين”، في جوهرها منطق السلطان والرعايا، لا منطق المؤسسات والمواطَنة. هذا التصور الأبوي و”الرعوي” و”الوصائي” للسلطة، الذي يبدو لأول وهلة إنسانياً أو حميمياً، هو في الواقع أداة هيمنة رمزية، يختزل العلاقة بين المسؤول والمواطن إلى علاقة رقابة من الأعلى إلى الأدنى، بدل أن تكون علاقة تعاقد قانوني ومساءلة متبادلة داخل منظومة مؤسسية.
صدام حسين عمّق هذه الصورة، فـ”جولاته التفقدية” كانت في الحقيقة استعراضاً سلطوياً وسلوكاً نرجسياً لزعيم يحتفي بذاته وبموقعه على قمة الهرم، وربما حتى ممارسة تعويضية لسنوات طفولة أو شباب شعر فيها بالحرمان والهامشية. تُسوّق هذه الجولات عبر الإعلام على أنها رعاية وحرص وقُرب من الناس، بينما هي تذكير دائم بأن “الزعيم يراك” وأنه “أقرب مما تتصوّر”، وأنه ليس فقط “أعلى سلطوياً” بل هو “أفضل إنسانياً وأخلاقياً” أيضاً، وأنه “مصدر الوصاية والرعاية والهداية”، وأن عليك أن تراه أيضاً وتخشى غضبه، وتخطب ودّه، وتشكر إحسانه، وتستشعر فضله، وتصفق وتهتف.
أما اليوم فيسعى المسؤولون من خلال استلهام سلوك صدام “الديكتاتوري” إلى تحقيق غاية “ديمقراطية” وهي تصدير صورة للجمهور بأن المسؤول يعمل ويتابع بنفسه كل صغيرة وكبيرة في دائرته ويحقق “الإنجازات” الخدمية والتنموية، وبالتالي هو يستحق أن يُعاد انتخابه مرة أخرى وتجديد ولايته في منصبه. إنه نوع من الإيهام الدعائي والدرامي فالمسؤول يريد أن يقول للمواطنين إن ما تشاهدونه أمام الكاميرات هو ما يحصل في الأروقة السياسية والحكومية فعلياً وفي كل لحظة، فحياة المسؤول، كما يعرضها السلوك التمثيلي والاستعراضي، كلها حرص ومتابعة وكفاح من أجل تحقيق أعظم الإنجازات للمجتمع كما أنه دائم التواجد في الميدان بين الجماهير وليس في مكتبه الفخم. هذا السلوك التسويقي صار العراقيون يطلقون عليه عبارة وصفية ساخرة وتهكمية هي “صوّرني وأنا لا أدري”!
ما نراه اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي من سلوك نواب ونائبات ووزراء ومدراء عامين ومستشارين وأعضاء وعضوات مجالس محافظات ورؤساء جامعات وعمداء كليات وقادة عسكريين يقتحمون الدوائر الحكومية وردهات المستشفيات وقاعات الامتحانات ومواقع البناء وميادين التدريب بزياراتهم المفاجئة أو المُرتّبة مسبقاً مصحوبين بالحراس والمرافقين والمصوّرين ليس سوى إرث مستمر لذلك السلوك المسرحي الفوقي الذي يرجع إلى أنظمة سلطانية وثورية وشمولية وعسكرتارية تتمحور ماكنتها الدعائية حول صورة “الزعيم المخلّص” و”القائد الضرورة” و”الرئيس الأب” التي تغري بها الجماهير وتستلب وجدانها.
ولا تقتصر مشكلة “الجولات التفقدية” على رمزيتها السلطوية، بل تمتد إلى أثرها العملي المربك. فحين يقتحم مسؤول رفيع مستشفى برفقة المسؤولين الأدنى وعناصر الحماية الشخصية وموظفي التغطية الإعلامية، فإن ما يُسمّى بالزيارة التفقدية يتحوّل فعلياً إلى انتهاك لخصوصية المرضى، وإقلاق لراحتهم، وتشويش على عمل الكوادر الطبية التي تُستنزَف في تنظيم الاستقبال والإجابة على أسئلة الضيف الكبير بدل أداء مهامها الفعلية. وهذا سلوك احتفالي استعراضي متطفل، غالباً ما يُوظَّف انتخابياً في ظل حملة ترويجية ممتدة على مدار تواجد المسؤول في منصبه. وهو أيضاً انتهاك للسيادة المؤسسية التي يحميها القانون. والأمر نفسه ينطبق على زياراتهم إلى الدوائر الحكومية، حيث يعيد المسؤول إنتاج تراتبية أخلاقية زائفة تضعه في موقع الرقيب الأعلى والمُوجِّه، وتضع الموظف في موقع المتلقّي الخاضع العاجز الذي ينتظر التعليمات الشفوية من مسؤول لا يُعامل بوصفه أعلى إدارياً وأكثر خبرة وظيفية فقط، وإنما باعتباره “أدرى معرفياً” من أصحاب التخصص أنفسهم وحتى “أرقى طبقياً” وربما “أفضل إنسانياً” من موظفيه. وتبلغ المفارقة ذروتها حين يُشاهد الجمهور المسؤول في صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يوزّع الملاحظات والتوجيهات في مجالات لا تمتّ بصلة لتخصّصه أو صلاحياته، فما الذي يعرفه مدير عام حاصل على شهادة في القانون، مثلاً، عن التفاصيل العلمية والتقنية في البناء والإنشاءات حتى يتفحّص أمام عدسات التصوير أعمال ترميم بناية أو حفر أساسات أو تبليط شارع؟ إنها بيروقراطية المظهر، لا جوهر المسؤولية.
إن الرقابة والمتابعة وتقويم الأداء كلها ممارسات علمية وتخصصات مهنية تُدرّس في الجامعات وتتم على يد منظومات خبيرة ووفق معايير محددة، وهي جزء من العمل الرسمي للمؤسسة وليست منّة أو تفضّلاً أو مبادرة إعجازية من الوزير أو المدير العام في أوقات فراغه. ووظيفة المسؤول الحكومي هي تفعيل الإجراءات الرقابية والتقييسية والتقويمية في مؤسسته على كل مفاصل العمل وتفاصيله من خلال الأذرع المؤسسية نفسها وليس من خلال تقديم نفسه بوصفه “الرقيب الأعلى” و”المصدر الأوحد” للمعرفة والخبرة والدراية و”المنقذ المتفرد” للدولة والمجتمع من الفساد والإهمال وسوء التدبير!
إن الاستمرار في ترويج مشاهد الجولات الميدانية المنقولة إعلامياً بوصفها دليلاً على الكفاءة والحرص لا يُعبّر إلا عن عجز عميق في فهم الدولة والوظيفة والمسؤولية. فالمؤسسات تُبنى بالأنظمة، لا بالهتاف والتلويح باليد للجمهور، وبالشفافية، لا بعدسات الكاميرات، وبالمسؤولية المتبادلة، لا بالدعاية والتفخيم وتسويق هالة إعلامية مصطنعة حول المسؤولين لتحويلهم إلى “رموز وطنية” و”أيقونات أخلاقية” و”مُنقذين من الشر والفساد”، وليس مجرد “موظفين عموميين”.
وما لم يُغادر الخطاب الرسمي العراقي هذه البنية الرمزية المستهلكة، ستبقى العلاقة بين المواطنين والمسؤول، في أحسن الأحوال، مثل جمهور ينتظر صعود نجمه على المسرح ليبدأ بالهتاف والاحتفاء وإلقاء الورود، لا شريكاً فاعلاً في منظومة مواطَنة قائمة على الحقوق والواجبات. إن الدولة التي يُعاد تمثيلها يومياً على خشبة السلوك الاستعراضي، لا يمكنها أن تنهض فعلياً من كبواتها وأزماتها، وستبقى ترزح تحت ركام الثقافة السياسية المتآكلة والتقاليد البيروقراطية المتهالكة.