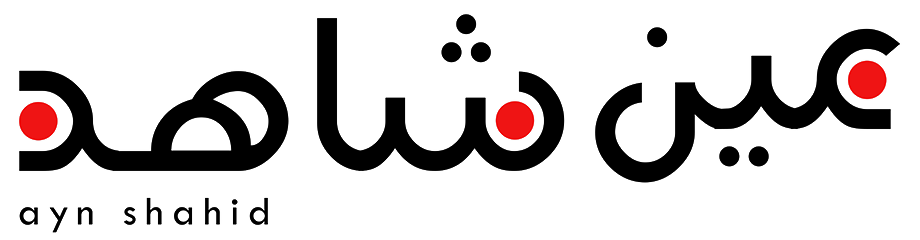عدنان عبدالله الجنيد.
في الزمنِ القديم، حين همَّ أبرهةُ الحبشي بهدمِ الكعبة، لم تتأخّر السماءُ عن نصرةِ البيتِ الحرام.
لكنْ قبل أن تتدخّل طيرُ الأبابيل، وقف عبدُالمطلب رمزًا للمروءةِ القبليةِ والمسؤولية، وأعلن موقفَه بشموخ، ثم عاد وترك الأمرَ لله، فتجلّى التدخّلُ الإلهي بأوضحِ معانيه، وأُبيد جيشُ أبرهة بالحجارةِ المصوّبة من طيورِ السماء، لتبقى الكعبةُ مصونةً من عدوانِ المتغطرسين.
لكنْ في مواقفَ لاحقة، حين تكرّر العدوانُ على مكة، لم تهطل الطيرُ، ولم تُرسل السماءُ حجارتَها، كما حدث في واقعةِ يزيد بن معاوية أو الحجاج بن يوسف الثقفي، حين رُمِي البيتُ الحرام بالمجانيق، وهُدّدت حُرمته بيدِ من يدّعون الإسلام.
هنا، تغيّب التدخّلُ الإلهي، لا لأنّ الله غافلٌ – وحاشاه – بل لأنّ الأمة ذاتَها غابت، وغيّبت نفسَها عن الميدان.
لم تكن هناك وحدةٌ، ولا موقف، ولا ميثاقُ عزّ، بل كانت الانقساماتُ والفتنُ السياسية قد مزّقت الصفوف، حتى باتت الحرماتُ تُنتهك بأيدٍ من داخل الجسدِ الواحد.
فهل تتدخّلُ السماءُ حين يصمتُ أهلُ الأرض؟
وهل يُنصرُ البيتُ حين يقفُ خدّامُه في صفِّ من يرجمونه؟
الجوابُ تحمله سننُ الله الثابتة:
﴿ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾.
إنّ غيابَ طيرِ الأبابيل ليس تخلِّيًا من الله، بل هو تخلٍّ من الأمة عن مسؤولياتها، وتراخٍ في مواجهة الباطل، وانقسامٌ يُضعفُ الموقف، ويُمهِّدُ للغزاة.
وما أشبهَ اليومَ بالأمس!
ففي غزّة اليوم، يُقصفُ الأطفال، وتُدفنُ الطفولةُ تحتَ الأنقاض، وتُحاصرُ الأمهاتُ بالجوعِ والدموع، والعالَمُ في صمتهِ يتواطأ، والعربُ بعضُهم يُبارك، وبعضُهم يُفاوض، وبعضُهم يُصفّق...
لكن... طيرُ الأبابيل لم يأتِ بعد.
لماذا؟
لأنّ الأمة – إلّا من رحمَ ربّي – صمتت، أو تخلّت، أو شاركت.
وقد يتساءلُ البعض: أين وعدُ الله؟
فنقول: إنّ وعدَ الله حقّ.
﴿ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾
لكنّ هذا الوعد له شروط، وله سننٌ لا تُحابِي أحدًا، ولا تُجاملُ صامتًا ولا متخاذلًا.
فكما لم تُنصر مكة زمن الحجاج، لن تُنصر غزّة بالصمت، ولا بالقُبلات على خدودِ الاحتلال، ولا باتفاقياتِ التطبيع، ولا بمنابرِ المسايرة.
الوعدُ الإلهي لا يتأخر، بل ينتظر الصادقين:
ينتظرُ أن تنفضَ الأمةُ عن نفسِها غبارَ التبعيةِ والخوفِ والتخاذلِ والتشتّت، وتستعيدَ وعيَها، وتُوحِّدَ صفَّها، وتُعيدَ تصنيفَ من معها ومَن عليها، وتُسمِّي الأمورَ بمسمياتها، لا أن تساويَ بين الذئبِ والضحية، وبين من يُحاصر ومن يُذبَح.
صرخةُ طفلِ غزّة اليوم، هي نفسُها صرخةُ الكعبةِ حين رُميت بالمجانيق.
لكن... هل من عبدالمطلب ينهض؟
هل من جيلٍ يُوقظ الطوفان؟
هل من أمّةٍ تُبدِّل صمتَها طوفانًا، وتُبدِّل خوفَها أمنًا، وجوعَها كرامةً؟!
وبعد أن تبيَّن سببُ التأخير، فإنّ موقفَ عبدالمطلب سيأتي، لكنّه يأتي من اليمن، من قائدِ الأنصار، ناصرِ الطوفان، مفلقِ البحار؛ من حيثُ تُصاغُ المواقفُ بالإيمان، وتُكتَبُ المعادلاتُ بصواريخِ الوعيِ والوفاء، لا ببروتوكولاتِ العار والانبطاح.
من هناك، من قممِ صنعاءَ وصمودِ صعدة، حيثُ الأنصارُ لا يساومون، ولا ينامون حين تُستغاثُ القدس، ولا يبيعون دينهم مقابلَ فضائياتِ العار.
الخاتمة:
إنّ طيرَ الأبابيل لن يتأخر، ولكنّه لا يُحلّق فوقَ أرضٍ خانعة، ولا يهبطُ على أمّةٍ خانت ميثاقَها مع الله.
إنّه ينتظرُ أمةً تخلعُ الخوف، وتكسرُ القيد، وتصرخُ كما صرخ طفلُ غزّة:
"يا ربّ، أينَ أهلي؟!"
فيرُدُّ عليه الله من السماء:
"إنَّ أهلك في اليمن، وفي كلِّ قلبٍ ما زال يؤمن أنّ القدس تستحقّ الطوفان!"
"وليس خافيًا أن سبب هذا التمزّق والانقسام – قديمًا وحديثًا – كان في جوهره مؤامراتٍ من صُنّاع الفتنة، الذين مثّلهم اليهود سياسيًا عبر التاريخ، والذين احترفوا زرع الخلاف وإشعال الصراع وتمزيق الأمة من داخلها، كما وصفهم القرآن بأنهم
﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾، وما تزال أصابعهم اليوم تعبثُ بالجسد العربي، تحت عناوين السياسة والتطبيع والإعلام الناعم."