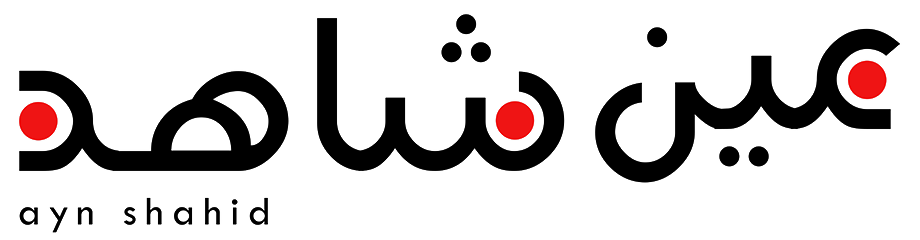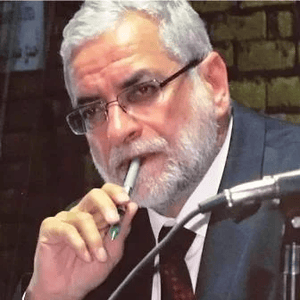
محمد عبد الجبار الشبوط ||
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، تدخل البلاد مرة أخرى في دوامة المشهد الانتخابي الذي بات مألوفًا في تفاصيله ومُحبطًا في نتائجه. تعود الطبقة السياسية، ومعها الطامحون الجدد للانضمام إليها، لتكرار نفس الأخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية منذ أول انتخابات بعد التغيير، وحتى يومنا هذا، دون مراجعة جادة أو شعور بالمسؤولية تجاه المصلحة العامة.
أولًا: الكثرة المفرطة في عدد الأحزاب والمرشحين
تشهد الساحة السياسية انفجارًا في عدد الكيانات السياسية، حيث تُسجَّل عشرات وربما مئات الأحزاب، معظمها لا يمتلك لا رؤية سياسية واضحة، ولا قاعدة جماهيرية حقيقية، ولا تنظيمًا داخليًا فعّالًا. وفي الوقت نفسه، يتقدم آلاف المرشحين، بعضهم لا يملك أي مؤهل سياسي أو ثقافي أو اجتماعي يبرر ترشيحه.
هذه الكثرة المفرطة تخلق حالة من الفوضى الانتخابية، وتُربك الناخب، وتُضعف إمكانية فرز نخب حقيقية قادرة على تمثيل الشعب بوعي ومسؤولية. بل إنها تساهم في تشتيت الأصوات، ما يؤدي إلى صعود غير المستحقين، وانحسار فرص الكفاءات الحقيقية. ويبدو أن غياب قانون صارم للأحزاب، وضعف الثقافة السياسية العامة، وتفشي النزعة الفردية والشخصانية في العمل السياسي، كلها عوامل تغذي هذه الظاهرة السلبية.
ثانيًا: غياب التنافس البرامجي
الأدهى من ذلك أن التنافس الانتخابي لا يجري على أساس البرامج والرؤى السياسية، بل على أسس طائفية أو عشائرية أو جهوية أو شخصية. تتراجع قيمة البرنامج الانتخابي أمام الولاءات الضيقة والروابط الأولية، ويُختزل العمل السياسي في شعارات عامة أو وعود شعبوية غير قابلة للتحقيق.
هذا النمط من التنافس يفرغ الانتخابات من مضمونها الديمقراطي الحقيقي، ويمنع تطور الحياة السياسية نحو النضج المؤسسي. فالأحزاب لا تُحاسَب على أدائها السياسي أو الاقتصادي أو التشريعي، بل يُعاد انتخابها على أساس شعبيتها في بيئتها الطائفية أو الجغرافية، بغض النظر عن فشلها في إدارة شؤون الدولة.
ثالثًا: الكتل والأحزاب الموسمية
ظاهرة أخرى لا تقل سلبية عن سابقاتها، وهي بروز كتل أو أحزاب موسمية تظهر فجأة مع اقتراب الانتخابات، وتختفي بعدها دون أن تترك أثرًا سياسيًا أو مجتمعيًا. هذه التشكيلات غالبًا ما تكون ذات طابع شخصي أو ظرفي، يُنشئها أفراد لتحقيق مكاسب انتخابية عابرة، لا تستند إلى قاعدة جماهيرية حقيقية ولا إلى رؤية فكرية أو برنامجية واضحة.
هذا السلوك يُفرّغ العمل الحزبي من مضمونه، ويحوّله إلى وسيلة انتهازية لتحقيق مصالح فردية، بدل أن يكون أداة لبناء دولة ومجتمع. كما يعيق تراكم الخبرة الحزبية والتنظيمية، ويُضعف ثقة المواطن بالأحزاب كأداة إصلاح وتغيير. فالحزب الحقيقي يُفترض أن يكون مؤسسة دائمة، تمارس نشاطها بين الانتخابات لا في موسمها فقط، وتستمد مشروعيتها من علاقتها المستمرة بالمجتمع وهمومه، لا من حاجة اللحظة الانتخابية.
نتائج مكرورة ومآلات خطيرة
النتيجة المتوقعة لهذا النمط من الممارسة الانتخابية هي إنتاج برلمان ضعيف، منقسم، غير قادر على التشريع الفعّال أو الرقابة الجادة، فضلًا عن دوره المحدود في تشكيل حكومات كفوءة. وهذا ما يُبقي الدولة في حالة من الضعف والارتباك، ويكرّس الفساد والمحاصصة، ويعطل مشاريع التنمية والإصلاح.
نحو تصحيح المسار
إذا أرادت النخبة السياسية، ومعها المجتمع المدني، إنقاذ العملية الديمقراطية من هذا المآل الكارثي، فعليها معالجة هذه الأخطاء البنيوية من الجذور. ويبدأ ذلك عبر:
1. إعادة تنظيم الحياة الحزبية من خلال قانون أحزاب صارم يشترط التمثيل الوطني والشفافية والتنظيم الداخلي.
2. تحفيز التنافس البرامجي عبر الإعلام والتثقيف السياسي، وربط تمويل الأحزاب ومشاركتها في الانتخابات بوجود برامج واضحة ومعلنة.
3. وضع شروط مؤسسية للترشح تمنع العشوائية وتضمن الحد الأدنى من الكفاءة السياسية والمجتمعية.
4. تحديث النظام الانتخابي ليشجع الكيانات الوطنية الجامعة ويقلل من التشتت والانقسام.
إن تجديد الديمقراطية لا يمكن أن يتم بمجرد صناديق الاقتراع، بل عبر تجديد ثقافة الانتخابات نفسها، وتصحيح الممارسات التي شوهت معناها.
فالديمقراطية ليست مجرد عملية انتخابية دورية، بل هي منظومة متكاملة من القيم والمؤسسات والسلوكيات، تبدأ من داخل الأحزاب وتنتهي في بنية الدولة