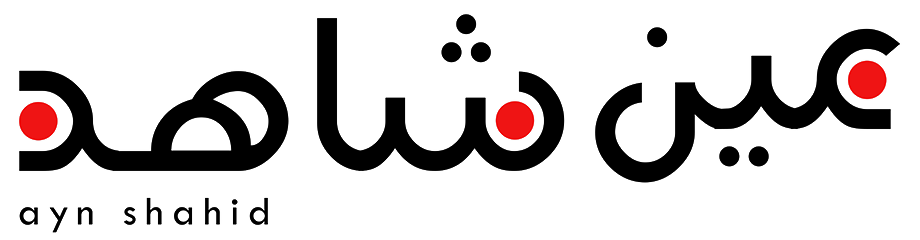ريما فارس ـ لبنان ||
لم يكن الإمام الحسين (عليه السلام) رجلًا عاديًا في سيرة الإسلام، ولا مجرد وريث لبيت النبوة، بل كان خطًا فاصلًا بين انحرافٍ كاد يطمس جوهر الدين، وبقاء الرسالة نقيّة كما نزلت على قلب جده محمد (ص). فقد واجه الإسلام بعد وفاة النبي الأكرم تحديات مصيرية، لم تكن عسكرية أو خارجية، بل داخلية خطيرة، تمثّلت في الالتفاف على نصّ النبوة، وتشويه مبدأ الخلافة الإلهية.
ففي غدير خم، أعلن النبي(ص) صريحًا: “من كنت مولاه، فهذا عليٌّ مولاه.” إلا أن هذا التعيين الإلهي ما لبث أن حُيّد جانبًا، واجتمع القوم في سقيفة بني ساعدة، وتم تنصيب من لم يُؤمر بهم، وتوالت السلطة من يد إلى أخرى، بعيدًا عن خطّ العصمة، ومصدر العلم الإلهي. الإمام علي، رغم علمه ومكانته، مُنِع من دوره الحقيقي، وعايش التهميش حتى استُشهد مظلومًا. ثم جاء الإمام الحسن ع، الذي أُرغم على صلحٍ مرّ مع معاوية، فكانت النتيجة أن تحوّلت الخلافة تدريجيًا إلى ملك وراثي لا علاقة له بروح الإسلام.
بلغ الانحراف ذروته حين نصب معاوية ولده يزيد خليفةً بعده، متجاوزًا كل مقاييس الدين والعدل. كان يزيد صورةً فاضحة لانحراف السلطة: حاكمًا فاسقًا، مستهترًا بالدين، ساقطًا أخلاقيًا، أراد أن يُشرعن فساده ببيعة الإمام الحسين ع، كي يُضفي على ملكه قداسة دينية.
لكن الإمام الحسين ع، بحكمته الإلهية، أدرك أن القبول ببيعة يزيد يعني الاعتراف بكل ما جرى من انحرافٍ منذ السقيفة، والسكوت عن تحول الإسلام من دين إلى مظلّة للطغيان. فرفض البيعة، وقالها بوضوح:
“إني لم أخرج أشِرًا ولا بطرًا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي…”
لم تكن ثورته بحثًا عن سلطة، بل صرخة في وجه التاريخ المنحرف، وإعلانًا أن الدين لا يُباع، وأن القيادة لا تُغتصب. بهذا الوعي، سلك الإمام درب كربلاء، وهو يعلم أن دمَه سيوقظ أمةً بأكملها.
وكربلاء لم تكن لحظة مأساة فقط، بل كانت وما تزال مدرسة للمقاومة الحيّة، فيها علّم الإمام الحسين العالم أن الدم إذا اختلط بالإيمان ينتصر على السيف. لم يُقدّم نفسه فحسب، بل حمل عياله، نساءً وأطفالًا، إلى ساحة الموت، ليقول إن الثورة ليست غزوًا، بل تضحية مطلقة في سبيل الحق.
وقد كرّم الله الإمام الحسين ع بهذه التضحية الخالدة، وجعل منه “سيد الشهداء”، لأنه لم يترك شيئًا إلّا وقدّمه. حتى طفله الرضيع، لم يُستثنَ من الفداء. هكذا أصبحت كربلاء رمزًا لكل المسلمين، محرابًا لا يُطفأ نوره، ومدرسةً لا تُغلق أبوابها، لأنها لم تُبنَ بالكلمات، بل بالدموع والدماء.
بكربلاء، لم يُهزم الحسين ع، بل انتصر حين سقط واقفًا، وسقطت معه كل أقنعة السلطة الزائفة. انتصر حين أبقى للإسلام روحه، ورفض أن يُدجَّن الدين باسم المصلحة والسكوت. ومنذ ذلك اليوم، صار اسمه رايةً للمظلومين، وصوته هتافًا في ضمير كل مقاوم:
“هيهات منا الذلة.”